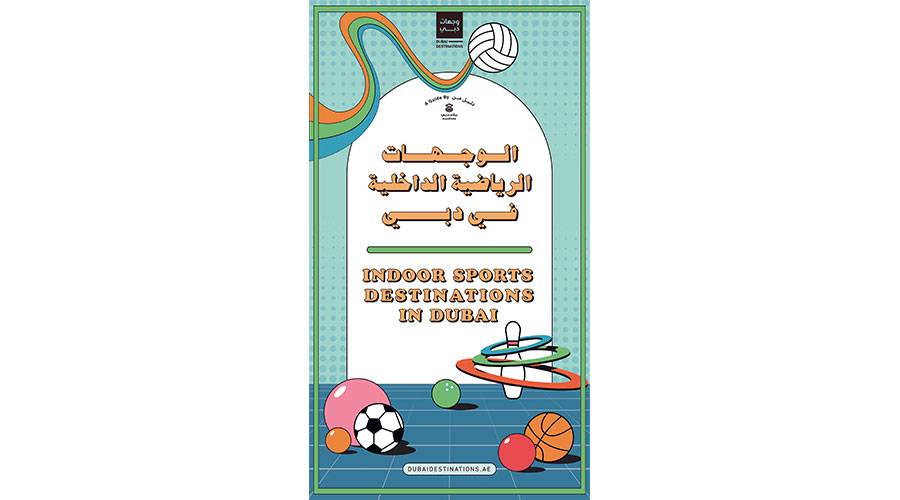منذ بدايات الشعر العربي قبل الإسلام، ارتبطت النصوص الشعرية بالمكان، إذ تعارف وقوف الشاعر على الأطلال، ووصف الطبيعة، الذي تطور من الطلل إلى وصف الطبيعة، ومن خلاله استعادة الذكريات والأيام والمواقف، إلى أن اعتبره بعض الدارسين شعرًا مكانيًا في ارتباطه بالبيئة التي أنتجته، ومثلت صوره لوحات منقولة بدقة وبراعة عن البيئة التي يعيش فيها.
الاهتمام بدراسة المكان في الأعمال الأدبية والشعرية تحديدًا أقدم من الشعر العربي، إذ يرجع الأمر إلى أفلاطون «428-348 ق.م»، وتوالت الاهتمامات الفلسفية بتتبع تفاصيل المكان في الكتابات الإبداعية، إلى أن نصل إلى الفيلسوف الفرنسي جاستون باشلار في دراسته «جماليات المكان»، متوقفًا أمام ما عُرف ب«المكان الفني»، أي «التحول من عالم الحياة اليومية بحسيته وأشيائه وظواهره المتنوعة والمختلفة إلى عوالم فعالة من التخيل عبر لغات مختلفة: علامات لغوية، وألوان، وأصوات، وصور، حيث الخبرة المباشرة الحدسية بالأشياء إلى الوعي الجمالي بهذه الأشياء ودورها».
تبدو دراسة باشلار فعليًا انتصارًا للرؤية التي تعتبر «الشعر ذاكرة للمكان»، وهو ما نتوقف أمامه في هذه السطور، من خلال التعريج على نماذج عربية وغير عربية، قدم من خلالها الشعراء نصوصًا تخص مكان ما، انطلاقًا من أهميته داخل النص الشعري، إذ نعتقد في بعض الأحيان أننا نعرف أنفسنا من خلال الزمن، في حين أن كل ما نعرفه هو تتابع تثبيتات في أماكن استقرار الكائن الإنساني الذي يرفض الذوبان. إن المكان، وحسبما يشير باشلار، يحتوي على الزمن مكثفًا هذه هي وظيفته، كما أن وظيفة الشعر الكبرى هي أن يجعلنا نستعيد أحلامنا.
إيقاع
تبدو أهمية المكان وطبيعته داخل النص، من خلال التحكم في حركة إيقاع القصيدة، سواء الإيقاع الموسيقي أو إيقاع الحركة الداخلية للجمل الشعرية، فالشاعر الذي يصف مكانًا صحراويًا لا يتساوى إيقاع نصه مع شاعر يصف بحرًا أو مدينة صاخبة، فسرعة الانتقال من حدث إلى آخر، فضلاً عن كونه عنصرًا ضابطًا للحالة النفسية والأجواء العامة داخل النص، فدوران الكتابة في مكان موحش يفرض حالة نفسية مغايرة حال دورانها في مكان أليف مثلًا.
إذًا، مثّل المكان أحد أهم الملامح الأساسية في الشعر العالمي، بما يعني علاقة الشاعر بالماضي والذكرى، وحلّ الحزن سمة أساسية وكامنة وراء وصف معالم الطلل أو الحيز الجغرافي للنص، وبدت مطالع النصوص لحظة بكاء بمثابة التعبير عن الصراع بين الحاضر والغائب، بين لقيا الحبيب وفقده، بين العمار والجدب، بل بين الحياة والموت «إن الخيام اللواتي جئت تطلبها/ بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا».
تنويعات على المدينة
حديثًا، مثلت صورة المدينة في شتى تنويعاتها مادة دسمة للأدب العالمي طوال القرنين الماضيين، خاصة منذ أن عرفت البشرية الثورة الصناعية، باختراع الآلة البخارية في إنجلترا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ومع زيادة نزعات التحديث والتمدن، كان الشعراء يلقون على المدينة أسباب ما سموه بالانهيار الحضاري وضياع الإنسان وتشيّئه، كقصيدتي الشاعر الإنجليزي «ت س إليوت» «الأرض الخراب» و«الرجال الجوف»، فضلًا عما كتب عن باريس، الأمر الذي دفع الكاتب الفرنسي آلان بولدوي، الذي حاز شهادات عليا في الفنون التطبيقية والرحالة الكبير إلى تأليف كتابه الشهير «باريس الشعراء»، وتناول فيه قصائد ريلكة وفيكتور هيجو وفرنسيس كاركو، وغيرهم.
جراء تأثير الشعر الغربي على نظيره العربي، حلّت المدينة موضوعًا شعريًا في الديوان العربي الحديث بعيدًا عن وظيفة الوصف، والانتقال إلى الحمولات الإيديولوجية، فكان الرفض للمدينة بمثابة رفض لكل القيم المرتبطة بها، ولهذا اقترن بالثورة والرغبة في التغيير، الثورة على الأوضاع التي سادت العالم العربي، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية من استعمار وظروف سياسية متقلبة، وأحوال اجتماعية في حاجة ماسة إلى التغيير. وأحس الشعراء أنهم يعيشون في مدينة ليست لهم، مما ولّد فيهم إحساسًا بالغربة، وكان قد صار «لزامًا عليه أن يموت إلى الأبد» بتعبير أحمد عبد المعطي حجازي، أن يموت وهو حي.
إذًا، لم تكن الشعرية العربية ببعيدة عن مسارات البكاء على بكارة القرى وشجب صخب المدينة، والحنين النوستالجيّ إلى البلدات البعيدة، فحنّ بدر شاكر السياب إلى «جيكور» وأحمد عبد المعطي حجازي إلى «تلا»، وصلاح عبد الصبور إلى «الزقازيق»، ونجيب سرور إلى «أخطاب» وغيرهم. خاصة بعدما شعروا بوحدتهم في أجواء المدينة الصاخبة، ويقول حجازي: «هو الربيع كان واليوم أحد/ وليس في المدينة التي خلت/ وفاح عطرها سواي/ قلت أصطاد القطا/ كان القطا يتبعني من بلد إلى آخر».
تسجيل
كما أن الخريطة التاريخية للأحداث التي مر بها العالم العربي، قفزت بديوان العرب إلى أن يكون في مقدمة أدوات التمسك بالذاكرة، فكان الشعر حاضرًا في السويس 1956 وفي سيناء والقدس 1967، وفي بيروت خلال الحرب الأهلية، ودمشق وبغداد وعدن، وأغلب الحواضر العربية. وكان حضوره في هذه المرات تسجيلًا ورصدًا وإدانة للخراب، وانتصارًا للإنسان الذي وقف في مواجهة الشر والظلم والتعدي على الحقوق والأوطان، وكانت القصائد حائط صد ضد تآكل الذاكرة عن صورة المكان قبيل المرور بالأحداث المشار إليها سابقًا.
لا يمكن قراءة الديوان العربي دون التوقف مثلًا أمام أماكن محمود درويش، والذي تركزت قصائده من خلال «المكان» على التأكيد على خصوصية الهوية الفلسطينية، وما يعانيه أبناؤها من بؤس ومذابح في الشتات، ونتيجة طبيعية لاحتفاء نصوص الشاعر الفلسطيني بالمكان، قسّم عبد الرحمن ياغي حياة درويش إلى مرحلتين مكانيتين، الأولى النفي داخل الوطن المحتل، والثانية النفي خارجه، وهي مرحلة النضج والتفوق والمضي في دروب الإبداع الشعري، ويصعد في تلك الدروب حتى يصبح أمام الحركة الإبداعية الشعرية الحديثة.
رفض
داخل الديوان العربي الحديث، رفض حجازي المدينة ولعنها، وهو ما عد رفضًا لماديات العصر الحديث، تلك التي تهدد بضياع المعاني الإنسانية في ذاته، فوجد الشاعر نفسه غريبًا ضائعًا وسط زحام الناس الذين يسيرون دمى متحركة، ووسط البنايات الشاهقة التي تحد حركة الحرية والانطلاق، ووسط العلاقات الزائفة التي تحركها المصالح الوقتية السريعة، فيقول في ديوان «مدينة بلا قلب»، «هذا أنا وهذه مدينتي/ عند انتصاف الليل/ رحابة الميدان والجدران تل/ تبين ثم تختفي وراء تل/ وريقة في الريح دارت ثم حطت ثم/ ضاعت في الدروب».
تبدو الشوارع عند حجازي «قيعان نار/ تجتر في الظهيرة/ ما شربته في الضحى من اللهب/ يا ويله من لم يصادف غير شمسها/ غير البناء والسياج/ والبناء والسياج/ غير المربعات والمثلثات والزجاج». ولا تعني الشوارع هنا المكان المجرد؛ بل تشير إلى الأفراد الذين لا ينتمي إليهم الشاعر، ونتيجة لذلك تولدت فيه «حساسية خاصة حادة يشوبها القلق» نتيجة الانفصال بين الذات والمجموع وتميز الأولى وتفردها.
ضد المدينة
من حجازي إلى العراق، يتجلى موقف بدر شاكر السياب وقصائده من المكان، الذي حل موضوعًا رئيسًيا في أشهر نصوص الشاعر العراقي، وهنا ترى الناقدة العراقية نجود هاشم الربيعي أن مدينة السياب، لا تنمو نموًا طبيعيًا، وإنما تنمو وتكبر بالتهام الموتى والاتساع بالمقابر وليس بالعمران، هو نقد سياسيّ مبطن لهذا الموت السياسي بالقتل المباشر أو السجن والقمع والتعذيب أو بالفقر والإهمال والأحوال الاجتماعية السيئة. فالسياب يدين مرحلة الستينات السياسية وما رافقها من أحداث سياسية، فاتخذ مقبرة أم البروم واتساعها مناسبة لنقد النظام السياسيّ في عراق الستينات.
وهي رؤية ليست ببعيدة عما سبق أن أوضحه دارسو الشعر العربي الحديث، بشأن مدينة عبد الوهاب البياتي التي كان يصورها كمرادف للقهر والحرمان، وتصير موطن الطغاة الذين استبدلوا جلودهم ولبسوا أقنعة أخرى جعلت منهم تجارًا ومرابين في المدينة يحتلون غرف الفنادق الفارهة، ويمارسون علاقة القتل اليومي لأحلام الفقراء برغيف خبز وأحلام الشعراء بمدينة لا يسكنها رعب التحول، وعذاب الإنسان على يد أخيه الإنسان: «عرفتُ كيف استبدل الطغاة/ جلودهم في زمن الهزيمة/ ولبسوا أقنعة جديدة/ ورددوا الأغنية القديمة».
تباين ومعاناة
في نصوصه، التي شهدت حضورًا كثيفًا للمكان رسم أمل دنقل التباين الشديد بين ماضي الإنسان العربي وحاضره، وراح يعبر عن رؤيته لواقعه السياسي بواسطة ثلاث شرائح مكانية «الجدار والسجن والميدان»، واحتوى كل منها جزءًا من المعاناة التي مرّ بها الشعب في مطالباته بالحرية والاستقلال.
جوهر التغيرات التاريخية
أوضح الشاعر العراقي باسم فرات، في دراسة سابقة له، أن العلاقات المكانية في شعر بدر شاكر السياب «القرية - المدينة» تقوم بوظيفة الكشف عن جوهر التغيرات التاريخية، وكذلك ما يرتبط بها من تحولات اجتماعية وثقافية، وهذا ما أظهر القرية مؤنسنة، وجعل المدينة خالية من رداء الإنسانية؛ إذ نجد السياب يضع الصلة - صلته هو مع المدينة - في إطار محدود غالبًا ما يقوم على «الضدية» أو على تمثل «الوجه النقيض» للمحيط الذي يريد، وبدا السياب «خط الافتراق» هذا مع المدينة في قصيدته «المومس العمياء»، التي تتداعى فيها الصور لنبذ واقعها.
كما تجلت رؤية السياب لجيكور في إيجاد وخلق يوتوبيا، خاصة به «جيكور» التي عاد إليها كوسيلة اتصال مع العالم الخارجي، وحضارة ثقافية ضد ثقافة المدينة وجيكور قد لا تكون جيكور الحقيقية، بل جيكور الرمز والأسطورة التي لها تشكلها الخاص، وإيديولوجيتها المحتملة، فالعودة للماضي عودة للحلم لا للواقع فجيكور هذا الاسم تضخم ليصبح أكبر من المدينة، وأكبر من الوطن، إذ أقام له السياب ضرباً من اليوتوبيا، وذلك بالعودة إلى الريف أو القرية في محاولة جعل جيكور رمز اليوتوبيا مضادة للمدينة التي تصورها رؤيا يوحنا، على حد قول «فرات